
الشيخ محمد الفحام

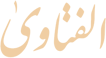
الفتوى رقم #3628
كيف نحول الحب الغريزي إلى حب بين العبد وربه
السؤال
كيف نحول الحب الغريزي البشري إلى حب بين العبد و ربه و بين العبد و سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سَيِّدِ الخَلْقِ رسولِ اللهِ وآلِهِ وصحبِهِ ومَنْ والاه، وبعد؛ فإنَّ الكلامَ عن الحُبِّ كلامٌ عن أَصْلٍ مِنْ أصولِ الفِطْرَةِ السَّليمةِ الْمُرْتَبِطَةِ بشفافيَةِ الروحِ العُلْوِيَّةِ السَّاميةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمُرادٍ إلهيٍّ جليل ألا وهو الحُبُّ الخالِصُ الْمُتَرْجَمُ بشهودِ معاني جملةِ التوحيدِ الكامِلَةِ لا إله إلا اللهُ سيدُنا محمدٌ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، والتي بها مِفْتاحُ الدُّخولِ إلى آفاقِ المعارفِ الجمالِيَّةِ الْمُتَضَمِّنَةِ فَهماً كامِلاً عن الخالِقِ العظيمِ المحبوبِ الأَوَّلِ للعبدِ مِنْ يومِ الخِطابِ الأوَّلِ يومَ خاطَبَ الأَرواحَ بقوله: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى) لذلك يُولَدُ المرءُ على تلكَ الفِطْرَةِ مِنْ أوَّلِ نَفْحَةٍ يَتَنَسَّمُها في أجواءِ الحياةِ الدنيا لِذا سَنَّ لنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نَبْدَأَهُ فيها بِما تَلَقَّاهُ في الملأ الأعلى قبلَ ظهورِهِ على مَسْرَحِ التَّكْليفِ عَبْرَ أُذُنَهِ اليُمْنَى وهي: كلمةُ التوحيد بألفاظِ الأذان، وفي أُذُنِهِ اليُسْرَى بأَلْفاظِ الإقامةِ كي يَخْنَسَ الشيطانُ، ولا يكونَ له سبيلٌ عليه، وهنا الإشارةُ الوجيهةُ إلى أنَّ فِطْرَةَ الإنسانِ كاملةٌ بأنوارِ التوحيدِ وأنَّ على الْمُتَلَقِّي لهذه الهَدِيَّةِ الربانيَّةِ أنْ يرعاها تَحْصيناً لما حَوَتْهُ مِنْ نِعْمَةِ الحُبِّ لله، فإنْ نُشِّأَ على ما تأَصَّلَ عليه في عالمِ الأرواحِ مِنَ التذكيرِ والتعليمِ والأُسْوَةِ الحَسَنَةِ عاشَ أُنْسَ الحُبِّ الإلهيِّ مِنْ غيرِ عَناء ، وإنْ أُهْمِلَ غُيِّبَتْ تلك النعمةُ الكامِنَةِ جُذُورُها في طَيِّ قَلْبِ الرُّوحِ تَشَتَّتَ وتَاهَ لاسِيَّمَا عند بُلوغِهِ مَبْلَغَ الرَّجالِ فَيَميلُ إلى حُبٍّ مِنْ نوعٍ آخَرَ في رحابِ مَظْهَرٍ جماليِّ يقُالُ له حُبٌّ مجازِيٌّ، فإنْ تُرِكَ ومَيْلَهُ، اسْتَمَرَّ هُوِيُّهُ وعِوَجُهُ إلى أنْ تَتَوَسَّعَ دائرةُ الانحرافِ عَمَّا خُلِقَ مِنْ أَجْلِهِ، وهنا تَبْرُزُ أَهْواءُ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ في نِظامِ ذلك الحُبِّ الْمَجازِيِّ نعم! وإنْ كانَ ما يُصْطَلَحُ عليه بالحُبِّ العُذْرِيِّ ذلك أنَّ تجلياتِ أنوارِ التوحيدِ على القَلْبِ تَرْجِعُ أدراجَها بِعِلَّةِ الرَّانِ الذي اسْتَحْكَمَ منه، فَحَوَّرَهُ وحَوَّلَهُ، والعِلاجُ النَّاجِعُ والنَّافِعُ حيالَ ذلك أنْ نَرُدَّ الحَقَّ إلى صاحِبِهِ بأَوْبَةٍ خالِصَةٍ وإِنابَةٍ سريعةٍ وتوبةِ صادِقَةٍ، ثم العُكُوفِ في محرابِ الأذكارِ لاسِيَّما القُرآن وصيغة التوحيد [لا إله إلا الله] بِكَثْرَة، مَسْبُوقَةً بِكَثْرَةِ الاستغفارِ، والصلاة والسلام على السيد المختار صلى الله عليه وسلم الناصِحِ أُمَّتَهُ بقولِه فيما أخرجه أحمد في مُسْنَده: (جددوا إيمانكم، أكثروا من قول لا إله إلا الله) وبقوله: (أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله) إضافةً إلى صُحْبَةِ الأَخْيارِ والبُعْدِ عن الشَّرِّ والأَشْرارِ وأَهْلِ الغفلةِ مِنَ التَّائِهين عن طريقِ الحقِّ طَريقِ الحبيبِ الأولِ سبحانه، ذلك أنَّ الحالَ يَسْرِي، فالصاحِبُ سَاحِبٌ والْمَرْءُ على دينِ خليلِهِ، وكما قال سيدي ابنُ عطاء رضي الله تعالى عنه: [لا تَصْحَبْ مَنْ لا يُنْهِضُكَ حالُهُ، ولا يَدُلُّكَ على اللهِ مقالُه] وكما ورد؛ (خَيْرُ الناسِ مَنْ يُحَبِّبُ اللهَ إلى النَّاس) ومَعْلومٌ أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا نَبَهَنَا على فَرْضِ حُبِّهِ إنَّما نَبَّهَنا على شيءٍ كامِنٍ أَصْلُهُ في قَلْبِ الرُّوحِ مِنْ عالَمِ الذَّرِّ، لأنه ما كلف النفس إلا بما آتاها كما فبيانه الجليل:(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا) فالْمُسْتعيدُ لهذا الأَصْلِ إنَّما هو مُسْتَخْرِجٌ ذلك العطاءَ مِنَ الداخِلِ الرُّوحِيِ الذي غُيِّبَ بِظُلُماتِ الغَفَلاتِ والمخالفات ألقِ السمع معي إلى قوله تعالى: (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ* كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) والحجابُ ظُلْمَةٌ تَمْنَعُ الحقائقَ وأَنوارَها، وتَحْجُبُهُ عن الثوابتِ والجُذورِ التي ما يَنْبَغِي أنْ تُهْمَلَ لَحْظَةً مِنْ زَمَنٍ العُمْرَ كُلَّهُ.
والحكمةُ مِنْ ذلك أنَّ في الذِّكْرِ جِلاءً لِلْقُلوبِ واسْتِنْزالاً لِلسَّكِينةِ والطُّمَأْنِينةِ وراحةِ البالِ وصلاحِ الحالِ لا سيَّما إذا كانت معها الآدابُ المعهودةُ في المؤمن مِنَ الحضور بشهود تجليات المذكور في نظام آداب الذكر مِنَ الطهارتَيْن الحسية والمعنوية مُسْتَقْبِلاً القِبْلَةَ مُتَحَقِّقاً بجوهرِ القولِ المرادِ منه. عندها يبدأُ الشُّعورُ بالعَوْدِ الحَميد إلى الفِطْرَةِ السليمة ما أَوَّلُهُ الأُنْسُ بما هو عليه، وذلك أوَّلُ الحُبِّ ذلك أنَّ الْمُحِبَّ يأنَسُ بِمَحْبُوبِهِ وقد ذكَرَهُ مُناجِياً لا سيَّما وأنَّه الحبيبُ الأَوَّلُ فكانَ العَوْدُ إليه أحمد، ثم تَتَوَسَّعُ دائرةُ الشُّعورِ بمقامِ الرِّضا عن المذكورِ سبحانه، وتَبْدأُ مَرْحَلَةُ الذَّوْقِ التي أَثْنَى على صاحبِها الصادِقُ المصدوقُ صلى الله عليه وسلم في الصحيح بقوله : (ذاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَنْ رَضِيَ باللهِ تعالى رَبّاً، وبالإسلامِ ديناً، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رسولاً)
ولعلك تسأل: إذن! فما قِصَّةُ حُبِّ سِوى اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم مِنْ أبٍ وولدٍ وزوجٍ وزوجةٍ أليس في ذلك شركةٌ مع الحبِّ لله ورسولِه؟؟؟
والجواب؛ أن إحاطتك بالمنهج النبوي تجلي لك الحقيقة بكمالاتها هو أنَّ هنالِكَ فَرْقاً بين الحُبِّ الخالِصِ لِمَعْنى في ذاتِه، والحُبُّ لِمَعنى في غيرِه، فالأول: هو الحبُّ مِنْ غيرِ عِلَّةٍ أي: حُبٌّ لذاتِ الله تعالى، وحُبٌّ لذاتِ رسولِهِ ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بِكَوْنِهِ هديةً إلهيَّةً وهو القائل: (إنما أنا رحمةٌ مُهداة)، والثاني: في اللهِ تعالى أي: تحبُّ الْمَرْءَ لِأَجْلِهِ وابتغاءَ وجهِهِ، ومِصداُقُهُ في شاهدين من الله ورسولِهِ صلى الله عليه وسلم، فالأول: قوله تعالى: (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)، والثاني: قولُهُ عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان، أنْ يكونَ اللهُ ورسولُهُ أحَبَّ إليه ممَّا سِواهُما، وأنْ يُحِبَّ المرءَ لا يُحِبُّهُ إلا لله، وأنْ يكْرَهَ أنْ يَعودَ إلى الكُفْرِ بعد إذْ أَنْقذَهُ اللهُ منه كمَا يَكْرَهُ أنْ يُقْذَفَ في النار) لاحِظْ كيف أنَّ الجْمَلَة الأولى في الحديثِ جَذْرٌ لِفُروع، وأساسٌ لِبِناء، وأنَّه مُفَسرٌ للآية، وبذا تُجْلَى حقيقةُ المنهجِ الربَّانيِّ في العلاقَةِ مع اللهِ تعالى ورسولِهِ صلى الله عليه وسلم، وشؤونِ الدنيا بأَكْمَلِها.
في الختام؛ ألا فَلْنَتَفَكَّرْ في حكمةِ الله العلية من بداية حياة المرء إلى نهايتها، وجَلالِ الرابطِ بين العبد وربه حتى الغافل، وكيف أن المخلوق في رحاب معيَّةٍ ربَّانيَّةٍ دائمةٍ، في السَّراءِ والضرَّاء، في الشِّدَّةِ والرَّخاء، في الإقبالِ والإِدْبار، وأنَّ حالَ الاضطِّرارِ يُجَسِّدُ حقيقةَ تلك الصلة التي لا تحتمل شركة بحال.
فاللهم! احْفَظْ علينا نِعْمَةَ الإيمانِ وسَلِّمْ لنا فِطرتنا لِلْحُظْوَةِ بِدخولِ الجنان، ورؤيةِ وجهك الكريم يا دَيان، يا مَنْ قلتَ في محكم البيان: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ*إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) (يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ*إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) أَجِبْ دعاءَنا برحمتك وجودك وكرمك يا ديَّان.
و لا تَنْسَ أنْ تَخُصَّني بدعواتِكَ المباركات.